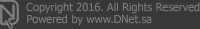أكتب لأُغير وأتغير..أبحث عن المختلف والأفضل.. أم قبل كل شيء.. وسيدة أعمال رغم كل شيء..وناشطة أجتماعية بعد كل شيء.. ممتنة لعائلتي.. وفخورة بمن حولي من أصدقاء..
إصداراتي
بين زيارتين
2017-05-10

في ٢٠١٠ كانت آخر زيارة لي إلى أميركا، أقسمت بعدها ألا أزورها إلا للضرورة، وذلك بسبب المعاناة التي واجهتها وغيري في المطار قدوماً ومغادرة، والتي جعلت كل جماليات البلد وفعالياتها السياحية وبساطة شعبها تتبخر أمام تعنّت الإجراءات وفضاضة التعامل والتعالي ضد أعراق وأجناس من دون الأخرى!
ولأن الظروف أقوى سلطة من القرار، اضطررت إلى شد الرحال إلى بلاد «العم سام» مرة أخرى نهاية الأسبوع الماضي، وأنا أحمل هم معاناة الوقت الذي يعادل دهراً ما بين وصول الطائرة، إلى الانعتاق من عنق زجاجة المطار بتبعاته وشخوص مسؤولية الفَضة المعقدة، ولكني حقاً ذهلت من حجم الاختلاف!
تلك الملامح الباردة الصارمة القاسية، التي لا تقبل سؤالاً ولا ترحم غريباً، أراد فك رموز إجراءات صعبت عليه باستفسار، تبدلت إلى ابتسامات تعلو الوجوه، وعشرات من الموظفين الذين يأخذون بيد كل قادم تائه إلى معرفة الطريق بحفاوة وصبر، مرحبين به بكل أدب واحترام، جهودهم متفانية بصبر في تقديم المساعدة لمن صعب عليه إجراء، ولكل سائل أراد لانجلاء حيرته جواب.
كذلك تفاجأت بتغير ملاحظ في طريقة إنهاء إجراءات السفر، من خلال أجهزه إلكترونية تخدم القادم بجميع اللغات، فتختصر الوقت أمام الزائر وضابط الجوازات، وعلى رغم أن الحذر ما زال موجوداً من تعاملهم مع أعمار معينة، تطغى على انفعالات مراهقتها وتصرفاتهم روح الطيش والجرأة واللامبالاة، ما يستدعي سؤالهم أكثر من غيرهم في مكتب منعزل عن صخب المسافرين، إلا أن ذلك تم بكل أدب واحترام مصحوباً بروح مداعبة وقفشات من تعليقات لطيفة، تمسح بأدب يتحلى به الضابط كل خوف ورهبة قد نشعر بها، بعكس ما كان في ٢٠١٠ عندما كانت الطريقة مبنية على الشك والتعالي وقلة الاحترام!
وهنا أتساءل:
ترى، ما الذي حدث فغير الأحوال، أهي سياسات تتبدل بتبدل الرؤساء، أم هي إفرازات حكمة سياسية تدفقت من عقل الرئيس ترامب وفريقه، ذلك الرئيس الذي راهن العالم كله على طيشه، فحبس أنفاسه خيفة وتوجساً وحذراً، من توليه رئاسة أكبر قوة تستطيع أن تحرك أدوات اللعبة السياسية المختلفة بذكاء ودهاء ومهارة على رقعة شطرنج العالم؟ وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال آخر: هل ظاهر شخصية ترامب تخفي وراءها فطنة عميقة، أدركت خطأ سنوات البرود الثمانية العجاف التي سادت عهد الرئيس السابق أوباما تجاه الشرق الأوسط ودول المنطقة، وبالذات المملكة، التي أثبت التاريخ أنها دولة لا تُلوى لها ذراع ولا ينحني لها رأس شامخ، والتي تسعى بجهد جبار وسرعة خارقة نحو تغير جذري سيجعلها خلال السنوات القليلة المقبلة مركزاً اقتصادياً متضاعف الأهمية في المنطقة، ما جعل المنطق الأميركي الجديد يعمل جاهداً على إذابة الثلج الذي تراكم، ليعود ربيع العلاقة بينهما يزهر من جديد؟
في المقابل، تعتبر زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة للمملكة، أول زيارة خارجية له بعد تولية منصب الرئاسة، وتصريحه الذي أوحى للعالم بأسره، مدى تمسك أميركا بالصديق القديم، الذي لا يمكن أن تتجاهله بلاد «العم سام»، باعتباره قوة اقتصادية وسياسية مستقلة وليست تابعة، ودولة ذات سيادة ولها رأي سياسي مؤثر تأثيراً مباشراً إقليمياً ودولياً، وقوة فعالة أثبتت جدارتها في محاربة الإرهاب وترميم ما أفسده المخربون والخونة في المنطقة، من دون أن يتأثر أمنها واستقرارها من جهة، ومن جهة أخرى أدرك العالم أن هذه البقعة المباركة من بقاع الأرض، هي الزحف الاقتصادي القادم الذي لا بد من استثماره والبحث عن فرصة فيه. والعلاقات السعودية - الأميركية ليست وليدة اللحظة، ولكنها ذات عمق تاريخي واستراتيجي يلقي بظلاله على المنطقة، ورأينا كيف أن توفقهما جنب المنطقة صراعات كثيرة، واستطاع ضبط زمام أمور كثيرة تهم البلدين وأطرافاً أخرى.
والتعاون السعودي - الأميركي يتعدى السياسة والاقتصاد ليصافح الثقافة والتعليم، فنجد أن أميركا هي البلد الأكثر استقبالاً لطلبتنا المبتعثين، وكلنا يرى التقارب المجتمعي بين البلدين وسرعة انسجام أبنائنا مع المجتمع الأميركي وثقافته، وحرصهم على التزود من العلم والمعرفة ونقلها لبلادنا معهم. ما قيل.. لمسته واقعاً في زيارتي الأخيرة لأميركا، جوازي الأخضر كان بطاقة مرور فاخرة وميسرة، ما جعلني أحتضن جوازي السعودي بحب، لأني أرى مكانة بلادي في كل مكان نسافر له ونجد نظرة الناس هناك فيه لنا.