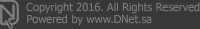أكتب لأُغير وأتغير..أبحث عن المختلف والأفضل.. أم قبل كل شيء.. وسيدة أعمال رغم كل شيء..وناشطة أجتماعية بعد كل شيء.. ممتنة لعائلتي.. وفخورة بمن حولي من أصدقاء..
إصداراتي
قراءة في «الهوية»
2017-01-22

الأسبوع الماضي تابعت برنامجاً تحدث عن الهوية الشخصية. كيف تكون السمة الجماعية التي تتكون منها الهوية المجتمعية فتجعل لها بصمة معينة تميزها عن بقية المجتمعات. متابعتي للبرنامج جعلتني أتساءل، هل ما زالت للمجتمعات بطاقة تعريف بهوية مستقلة في القرن الـ21، أم أن تلك البصمة التعريفية بها كمجتمعات لم تعد موجودة بسبب تغير نمطية الشخصية الإنسانية وهويتها بحيث لم تعد واحدة، أو هي واحدة، لكنها مركبة من مكونات متعددة بينها تنوع لا يمكن حصره. فأصبح إنسان هذا العصر، خصوصاً في المجتمعات المنفتحة، لا يجد إجابة دقيقة على هذا السؤال الذي يبدو بسيطاً، وهو «من أنا؟». هل ما زال هو فرد مستقل له إرادة، ويشارك في صنع القرارات، ولكنه في الوقت ذاته عضو في جماعة تضم آخرين، سواء أكانوا أبناء الوطن، أم أتباع دين واحد، أم مشجعي فريق رياضي، أم موظفين في مؤسسة كبرى، أم أتباع نظام غذائي مميز، أم غير ذلك من الولاءات التي تشكل إحدى ركائز الهوية؟
ومن يتأمل طويلاً في مسألة «الهوية»، يجد أنها تكشف عن القيم التي يؤمن بها الإنسان، والقناعات التي ترسخت داخله، والخبرات الجماعية التي تربطه مع آخرين، وتصوراته عن الحياة الناجحة. لذلك فالهوية هي مجموع الصور التي نرى بها الآخرين، والصور التي نريد أن يرانا بها الآخرون، ومدى تطابق هذه الصور بحقيقتهم وحقيقتنا نحن، أو على الأقل مدى التقارب بينهما، بحيث لا يسيطر التوتر على علاقتنا بأنفسنا وبمن نثرتهم متطلبات الحياة حولنا، وهذا طبيعي إذا كانت هذه الصور مصطنعة ومتكلفة، ولا تعكس سوى تلك الأقنعة ال نرتديها طوال الوقت، ليرانا بها الآخرون. فمن الطبيعي أن يتصرف الإنسان داخل أسرته بصورة مختلفة عما يفعل في مكان العمل، ومع أصدقائه، ومع الغرباء في الطريق. وفي كل من هذه المواقف يلعب دوراً مختلفاً، يظهر ذلك بوضوح حين يجلس معلم للحصول على دورة تدريبية، وينتقل من دور المعلم إلى دور المتعلم، وإذا به يتصرف كما يتصرف التلاميذ عنده، فربما يتحدث مع من بجانبه، ولا ينتبه للشرح، أو يشعر بالملل أو السخرية من طريقة الشرح، التي يتبعها المحاضر، ويتضامن مع بقية المتعلمين ضد المحاضر.
إذاً، فالاعتقاد أن الإنسان يكون على حقيقته، حين ينزع كل أقنعته، لا يعدو أن يكون وهماً، لأن هذه الأقنعة، هي جزء من حقيقة الإنسان. ومع الاعتراف بأهمية التفكير في الهوية، فإن اعتبار الإنسان نفسه محور الكون، والتفكير الأناني، وعشق الذات، يحرم الإنسان من امتلاك القدرة على الشعور بالآخرين، ومن الانتماء للجماعة، التي تعطيه أكثر مما تأخذ منه. في هذا العصر لم تعد هناك خطوط واضحة تفصل الجماعات المختلفة، ولذلك فإن الحساسية المرهفة المتعلقة بالهوية تتسبب في سلوكيات غريبة، مثل قرار مدينة جامعية أميركية بمنع الطلاب الأميركيين البيض من طبخ وجبات آسيوية، لأن الطلاب الصينيين اشتكوا من ذلك، باعتبار الطعام الصيني جزءاً من هويتهم، ولا يقبلون أن يتعدى أحد من غيرهم على ذلك. واستنكار مواطني بعض الدول، أن يرتدي الأجنبي الملابس التقليدية الخاصة بوطنهم، مثل أن يرتدي عامل من بنغلاديش الثوب الوطني السعودي.
وهناك اتجاه في الشركات العالمية الكبرى بأن تفرض هويتها على موظفيها، إذ لم تعد تكتفي بأن يضع الموظف خبراته وكفاءاته تحت تصرفها، بل تريد أيضاً أن يجعل شخصيته مِلكاً لها، فيتصرف تبعاً للتقاليد التي تفرضها الشركة، حتى ولو كانت تتناقض مع شخصيته. وأصبح الإنسان تابعاً لهذه الشركة، حتى خارج أوقات الدوام، إذ لم يعد غريباً أن يختار الهوايات، التي تفيده في عمله، بدلاً مما يرغب هو فيه، وحتى لا يشعر بالغربة في مكان العمل، يتخلى طوعاً شيئاً فشيئاً عن ميوله الشخصية، لمصلحة الثقافة السائدة في مكان العمل. لكن المشكلة تظهر، إذا انتقل إلى مؤسسة أخرى، ذات هوية مختلفة، ويكون عليه حينئذ أن يعيد برمجة سلوكياته وميوله تبعاً لها.
في عصرنا الحالي أصبح طبيعياً أن يقوم الإنسان بالتقاط صور «سيلفي» لنفسه طوال الوقت، مع أن ذلك كان مستهجناً في الماضي، وفي إطار الانشغال الكبير بالذات، الذي يصل في كثير من الأحيان إلى حد النرجسية.
ينشغل الإنسان عن العلاقات التي تربطه بمن حوله، مع أن جزءاً كبيراً من هوية الإنسان، يتشكل من خلال انتمائه إلى جماعة، وعندها يقول الإنسان عن نفسه: أنا سعودي، وحجازي، ومسلم، وعربي، ونصراوي أو هلالي، وحقوقي، ونباتي، وليبرالي، ورياضي، وأرامكوي،.... إلى آخر ذلك من مكونات الهوية. وهذا ما أعنيه بأن إنسان اليوم لم تعد تكفيه هوية واحدة، بل هو مجموعة هويات تشكلت من حاجته للتأقلم مع ظروف محيطة وأنماط جماعية ومجتمعية متباينة لن يستطيع أن يفتح أبواب الحياة التي تصادفه إن لم تقرأ بواباتها بطاقات التعريف الشخصية التي تناسب كلاً منها لتسمح له بالمرور من خلالها!