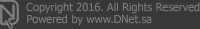أكتب لأُغير وأتغير..أبحث عن المختلف والأفضل.. أم قبل كل شيء.. وسيدة أعمال رغم كل شيء..وناشطة أجتماعية بعد كل شيء.. ممتنة لعائلتي.. وفخورة بمن حولي من أصدقاء..
إصداراتي
حروب الإعلام
2018-10-21
لم تستهوني السياسة يوماً للغوص في أعماقها لا متابعة ولا كاتبة، لأن شغفي وميولي هو التبحّر في عالم المجتمعات بأفرادها وجماعاتها ومجتمعاتها وما يتعلق بها من خبايا وأسرار، ولكني أجد نفسي الآن أتجه بأمر الولاء والحب والانتماء للمقالة السياسية أو الاجتماعية السياسية التي أكتب فيها عن وطني في خضم هذه الحملات الإعلامية الشرسة للنيل منه، مقالتي قد لا تروي عطش المتخصص في السياسة، ولكنها حتماً ستصب في نهر الولاء الوطني الذي يجري في عروق كل سعودي غيور، أُغرم بتراب الوطن وتشرب عشقه.
أفلام «الأكشن» السياسي المصاحب لقضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي تضعنا أمام تساؤلات إجاباتها المنطقية تختلف تماماً عن تلك الأجوبة المطروحة على صفحات الواقع، والتناقض الغريب بين تحليل العقول العقلانية المحايدة وحلها للغز اختفائه، وبين التحليلات الخيالية المبنية على سيناريوهات تعتمد على الفبركة المبالغ فيها تجعلنا نتساءل؛ ألهذا الحد تقف السعودية العظمى شوكة قاسية في حناجر مسوخ الحكومات ومرتزقة الإعلام؟!
ما يتعلق بمتناقضات أدلة الاتهام، الذي من شر بليته جعلنا نضحك كثيراً، ومحاولة توريط سعوديتنا العظمى بها، لن أناقشه هنا، ولن أتعب نفسي بالرد عليه، فهي أدلة لن يصدقها إلا ساذج غبي، أو طفل صدق أن أبطال أفلام الكرتون قد يقعون من أعلى جبل شاهق من دون الإصابة بأذى، أو من أعجب بسيناريوهات المسلسلات التركية التي لا يخلو أحدها من قتل وبلطجة وسط شارع مزدحم أو داخل حارة مكتظة بالسكان من دون أن يحرك أحد ساكناً، لأن ذلك كما أعتقد من ثقافة أهل البلد ما دامت من أساسيات مسلسلاتهم التي تعكس واقعهم، لذا فقتل وتقطيع وإذابة خاشقجي سيناريو مستمد من ثقافة العنف التركية الممزوجة بشيء من الدموية الفارسية وكثير من الطمع والنفاق القطري! أما نحن السعوديين، فحبكتنا في التعامل مع معارضينا أكثر وضوحاً وتعقلاً وذكاءً وشجاعةً وصدقاً، وتاريخنا يشهد.
النقطة الأهم التي يجب أن نقف عندها كثيراً هي تعاطي إعلامنا نحن مع هذه الهجمة الشرسة، وتقييمه مقارنة بإعلام الدول المغرضة، هل قوة إعلامنا وإعلامهم متعادلة؟ هل تفاعل إعلامنا كان كما يجب فقام بدوره على الوجه الأكمل في هذه الأزمة؟ وما الثغرات التي تتسرب منها قوة الرد المضاد كي نسدها قبل أن يملأها الأعداء بما يقلب رأي المتلقي العالمي ويقنعه بما يريد؟
للأسف تفاعل إعلامنا الرسمي وقنواتنا الفضائية، التي من المفروض أن تكون سعودية الانتماء، كان أضعف بكثير من التصدي للاعتداء الإعلامي الغاشم، فالحرب الإعلامية يجب أن تكون لها طرق يتم تحديثها باستمرار لتكون بقوة صواريخ الباتريوت، التي بأمر الله أخفقت كل هجمات الصواريخ الباليستية فارسية الصنع حوثية الاعتداء، ولكن مع كل العتب لم نشاهد إلا تفاعلاً إعلامياً تقليدياً لا يسمن الانتماء الوطني ولا يغني من الجوع إلى الحقيقة التي يجب أن تعد بإتقان في مطابخ الإعلام، فالتفاعل كان أضعف بكثير من قوة الهجوم، رد لا يتعدى برامج وتقارير ضعيفة المحتوى وكأن الوطن لا يتعرض لحرب إعلامية شرسة والعالم بشعوبه البسيطة لا سياسييه المتخصصين ينتظرون بشغف من ينتصر ليصفقوا له ويمنحوه ثقتهم.
المتابع لهذه الأزمة يلاحظ أن الرد الأقوى جاء عبر حسابات تويترية، على رغم أن شعبية تويتر منتشرة عندنا فقط، أما العالم فاستخدامه للفيسبوك أكثر بكثير، تغريدات تويتر كانت بجهود كثير من مواطنين بسطاء مع عدد لا يستهان به من مثقفي المملكة وكتابها ومسؤوليها المخلصين، مع غياب واضح لمشاهير السوشال ميديا الذين اعتدنا أن نغص بكثافة وجودهم عند كل إعلان تجاري يملأ الجيوب بأموال الوطن والمواطن أكثر من امتلاء قلوبهم بحب وطنهم. وهنا يطرح سؤال آخر، ما الحل؟
الحل أن يحاسب كل مقصّر، فالوطن خط أحمر، والدفاع عنه واجب على كل مواطن لنظهر أمام العالم كالجسد القوي الواحد، الحل أيضاً أن نعتمد التجنيد الإعلامي، بحيث نعتمد دورات ودبلومات متخصصة في فنون الحرب الإعلامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن نشجع الشعب وخصوصاً الأجيال القادمة على تعلّم لغات مختلفة نخاطب بها العالم من وراء شاشاتنا وإعلامنا، لنكون حواجز صد إعلامية لا يستهان بها يحسب لنا العدو ألف حساب، فالوطن غالٍ، والأمن والأمان مطلب الشعوب وغايتها، فلنحافظ على هذه النعمة التي منَّ الله بها علينا، ونتعلم فنون الحرب الإعلامية، لأنها الأقوى في هذا العصر.